العمر ان مضى
- Alaa Tamimi

- 22 يونيو 2025
- 3 دقيقة قراءة
ها أنا ذا، تجاوزت السبعين سنتين اليوم . لا احتفالَ يُزمِّرُ، ولا أضواءَ تُلمعُ، بل وقفةٌ صامتةٌ كتوقُّفِ المسافرِ في منتصفِ الطريقِ، يلتقطُ أنفاسَه، يُقلِّبُ نظرَه خلفَ ظهرِه، ثم يتأملُ المسافةَ المتبقيةَ. اليومُ، مرَّ كفيلمٍ صامتٍ يُعرضُ على شاشةِ الذاكرة: شوارعُ بغدادَ التي رَسمت طفولتي، دفاترُ الدراسةِ في ثانويةِ الكرخِ، خطواتي الأولى بكليةِ الهندسةِ في نهايةِ الستينياتِ. ثمَّ كانت المغادرةُ في بدايةِ الثمانينياتِ للدراسةِ العليا،
خرجتُ من العراقِ يومَها، حقيبتي ثقيلةً بأوراقٍ تختزلُ هويةً، وقلبي أثقلُ بما عجزتُ عن قولِه. كانت باريسُ – مدينةَ الضوءِ – مرفأً أولَ، فتحتْ لي أبوابَ المعرفةِ والشتاتِ معاً. في قاعاتِ جامعاتِها، كتبتُ أطروحتي، وشرعتُ أرسمُ ملامحَ رجلٍ قررَ ألا يستسلمَ للغيابِ. إن لم تكنْ ثمّةَ أرضٌ تثبُتُ فيها القدمُ، فلتُزرعِ الجذورُ في الكتبِ. كانت مقاومةً بالمعرفةِ.
ثم العودةُ منتصفَ الثمانينات لِأعملَ في "العراق الحبيبِ" عقداً كاملاً، قبل أن يأتيَ القرارُ الأثقلُ: الهجرةُ. ذلك الجرحُ النازفُ الذي لم تندملْهُ كلُّ المدنِ التي منحتني أسماءً مؤقتةً، كأنما تُخاطبُ غريباً.
ثم جاءت العودةُ المؤقتةُ، امتحاناً للضميرِ لا منصباً: أميناً للعاصمةِ الجريحةِ، بغدادَ. سعيتُ بين ركامِها، أبحثُ عن بصيصِ نظامٍ في قلبِ الفوضى، وعن معنى في زمنٍ أضاعَ معناه. تعلّمتُ أن الألغامَ لا تُزرعُ تحتَ الطرقِ وحدَها، بل وتُختبئُ تحتَ كلِّ فكرةٍ نبيلةٍ. مشيتُ على حافةِ الهاويةِ، حاملاً أملَ إعادةِ البناءِ في مدينةٍ تتنازعُها النيرانُ.
ثم كانت الهجرةُ الأخيرةُ إلى كندا، الأرضِ التي تمنحُكَ حقَّ البدءِ من جديدٍ، دونَ أن تسألَكَ: "مَن كنتَ؟". عدتُ إلى حُبِّي الأولِ: القاعاتِ الدراسيةِ والاستشارة الهندسية . أستاذاً جامعياً بين تورونتو والإماراتِ وباريسَ نفسِها، أنقلُ ما تعلّمتهُ لأجيالٍ من المهندسينَ. ألمحُ في عيونِهم شررَ طموحي القديمِ، فأضعُ بين أيديهم أدواتَ الحلمِ والتفكيرِ الحرِّ، كما وضعَها أساتذتي بين يديَّ ذاتَ يومٍ. دورةُ الحياةِ تكتملُ: من التلمذةِ إلى التعليمِ.
واليومَ، في هدوءِ هذا الصباحِ وأنا أخطو خطواتي في العقدِ السابعِ، لا يملؤني ندمٌ على ما فاتَ، ولا رغبةٌ في التفاخرِ بما أنجزتُ. يملؤني شيءٌ أعمقُ: **الرضا**. أدركتُ أن العمرَ الحقيقيَّ لا يُقاسُ بعددِ السنواتِ، بل **بكثافةِ التجربةِ وصدقِ المعنى** الذي نعيشُ من أجلهِ. لقد عشتُ بصدقٍ.
فيا زماني، كُنْ هادئاً فيما تبقى من رحلتِنا معاً. لم أعدْ أسعى وراءَ مجدٍ يتبخّرُ، بل أبتغي **وضوحاً** يثبُتُ. لا أريدُ طريقاً طويلاً يتعثّرُ فيه السائرُ، بل أريدُ طريقاً واحداً: **طريقاً يُشبهني**.
العقد السابع: توقُّفُ المسافِرِ واستشرافُ الوُضوحِ**
ها أنا ذا، تجاوزت السبعين. لا احتفالَ يُزمِّرُ، ولا أضواءَ تُلمعُ، بل وقفةٌ صامتةٌ كتوقُّفِ المسافرِ في منتصفِ الطريقِ، يلتقطُ أنفاسَه، يُقلِّبُ نظرَه خلفَ ظهرِه، ثم يتأملُ المسافةَ المتبقيةَ. اليومُ، مرَّ كفيلمٍ صامتٍ يُعرضُ على شاشةِ الذاكرة: شوارعُ بغدادَ التي رَسمت طفولتي، دفاترُ الدراسةِ في ثانويةِ الكرخِ، خطواتي الأولى بكليةِ الهندسةِ في نهايةِ الستينياتِ. ثمَّ كانت المغادرةُ في بدايةِ الثمانينياتِ للدراسةِ العليا،
خرجتُ من العراقِ يومَها، حقيبتي ثقيلةً بأوراقٍ تختزلُ هويةً، وقلبي أثقلُ بما عجزتُ عن قولِه. كانت باريسُ – مدينةَ الضوءِ – مرفأً أولَ، فتحتْ لي أبوابَ المعرفةِ والشتاتِ معاً. في قاعاتِ جامعاتِها، كتبتُ أطروحتي، وشرعتُ أرسمُ ملامحَ رجلٍ قررَ ألا يستسلمَ للغيابِ. إن لم تكنْ ثمّةَ أرضٌ تثبُتُ فيها القدمُ، فلتُزرعِ الجذورُ في الكتبِ. كانت مقاومةً بالمعرفةِ.
ثم العودةُ منتصفَ الثمانينات لِأعملَ في "العراق الحبيبِ" عقداً كاملاً، قبل أن يأتيَ القرارُ الأثقلُ: الهجرةُ. ذلك الجرحُ النازفُ الذي لم تندملْهُ كلُّ المدنِ التي منحتني أسماءً مؤقتةً، كأنما تُخاطبُ غريباً.
ثم جاءت العودةُ المؤقتةُ، امتحاناً للضميرِ لا منصباً: أميناً للعاصمةِ الجريحةِ، بغدادَ. سعيتُ بين ركامِها، أبحثُ عن بصيصِ نظامٍ في قلبِ الفوضى، وعن معنى في زمنٍ أضاعَ معناه. تعلّمتُ أن الألغامَ لا تُزرعُ تحتَ الطرقِ وحدَها، بل وتُختبئُ تحتَ كلِّ فكرةٍ نبيلةٍ. مشيتُ على حافةِ الهاويةِ، حاملاً أملَ إعادةِ البناءِ في مدينةٍ تتنازعُها النيرانُ.
ثم كانت الهجرةُ الأخيرةُ إلى كندا، الأرضِ التي تمنحُكَ حقَّ البدءِ من جديدٍ، دونَ أن تسألَكَ: "مَن كنتَ؟". عدتُ إلى حُبِّي الأولِ: القاعاتِ الدراسيةِ. أستاذاً جامعياً بين تورونتو والإماراتِ وباريسَ نفسِها، أنقلُ ما تعلّمتهُ لأجيالٍ من المهندسينَ. ألمحُ في عيونِهم شررَ طموحي القديمِ، فأضعُ بين أيديهم أدواتَ الحلمِ والتفكيرِ الحرِّ، كما وضعَها أساتذتي بين يديَّ ذاتَ يومٍ. دورةُ الحياةِ تكتملُ: من التلمذةِ إلى التعليمِ.
واليومَ، في هدوءِ هذا الصباحِ وأنا أخطو خطواتي في العقدِ السابعِ، لا يملؤني ندمٌ على ما فاتَ، ولا رغبةٌ في التفاخرِ بما أنجزتُ. يملؤني شيءٌ أعمقُ: **الرضا**. أدركتُ أن العمرَ الحقيقيَّ لا يُقاسُ بعددِ السنواتِ، بل **بكثافةِ التجربةِ وصدقِ المعنى** الذي نعيشُ من أجلهِ. لقد عشتُ بصدقٍ.
فيا زماني، كُنْ هادئاً فيما تبقى من رحلتِنا معاً. لم أعدْ أسعى وراءَ مجدٍ يتبخّرُ، بل أبتغي **وضوحاً** يثبُتُ. لا أريدُ طريقاً طويلاً يتعثّرُ فيه السائرُ، بل أريدُ طريقاً واحداً: **طريقاً يُشبهني**.
نشرت على مدونتي الشخصية

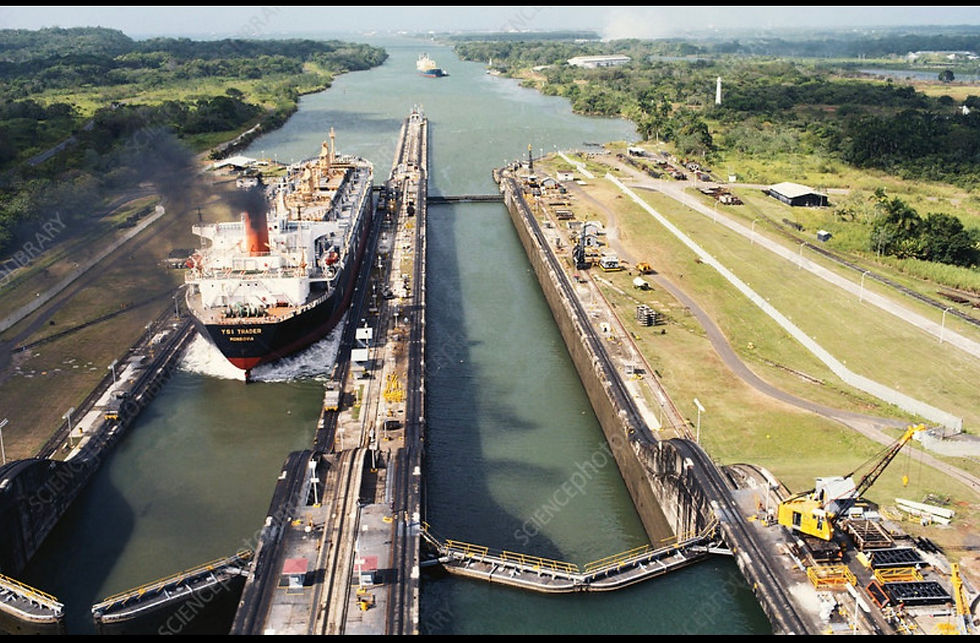
في رحلة العمر الايام مسرعة والعمر يعكس الخبرة والحكمة هذه الخبرة تجعلك تستصغر امور كثيرة . الحمد لله الذي ساعدنا للعيش في بلد يقدر ويهتم بالمسنين وان مسيرتنا في الحياة كانت نظيفة وبصفحة خالية من السلبيات.